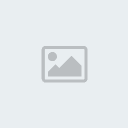عاتبني بعض الأصدقاء من الكتاب والمثقفين حين صرحت ذات مرة قائلا بنوع
من الحزن والمرارة: "المثقف الجزائري المعرب كسول" وعاتبني أيضا، ربما نفس
الأصدقاء، حين قلت وبالمأساة ذاتها: القارئ المعرب لا يعرف قراءة الرواية
وهو يمثل الرقيب الخطير على حرية الإبداع، أخطر من أي رقيب لأية سلطة
قامعة.
واليوم أريد أن أعود إلى هاتين المقولتين لأناقشهما على ضوء تجربتي مع
القراء وانطلاقا من قراءتي الخاصة لمشهد المثقفين ومشهد الثقافة في بلادنا.
أولا في كسل المثقف الجزائري المعرب:
يبدو لي أنه ومنذ الاستقلال لم يقد المثقف المعرب تجربة ثقافية اجتماعية
تغييرية جادة ولم يقدم اقتراحات فاعلة وميدانية استطاعت أن تخلخل المجتمع
الثقافي الجزائري، دون شك الاستثناء يؤكد القاعدة، لقد ظل هذا الفصيل من
المثقفين المعربين يعيش على فتات موائد السلطات المتعاقبة على البلاد
بانتهازية كبيرة وبتقلبات أيديولوجية خطيرة من أقصى اليمين إلى أقصى
اليسار. كان المثقف المعرب في الجزائر وفي جميع المراحل الصعبة التي
قطعتها الدولة الوطنية في تشكلها وتمأسسها توكل له مهمة "التزويق"
و"التبرير" السياسيين، ويكون راضيا عن هذه المهمة، أو يقوم بدور المتفرج
المستقيل من اللعبة دون أن يعلم بأنه، رغما عنه، هو جزء فيها ومحسوب
عليها.
على الرغم من الحماس التاريخي والصادق الشعبي والثقافي والعقائدي الذي
رافق استقلال الجزائر والمتمثل في مديح العروبة سياسيا ولغويا وثقافيا وما
رافقها في المقابل من عداوة وكراهية الفرنسة لغة وسياسة وجغرافيا، إلا أن
المثقف المعرب لم يستطع أن يطرح بديلا تغييريا جادا لا على المستوى
الثقافي ولا على المستوى التربوي، مع أننا ومنذ بداية الاستقلال كنا نملك
نخبا ثقافية معربة كثيرة تعلمت وتخرجت من مدارس وجامعات في كل من تونس
ومصر وسوريا والمغرب والكويت وبغداد، في هذه المرحلة التاريخية الحساسة
أيضا اكتفى المثقف المعرب بالجلوس في مدرج التفرج أو في بيوت العزاء أو
واقفا على شواهد الموتى، ثم جاءت سياسة التعريب مع بداية السبعينيات، وأنا
هنا لا أريد أن أقيم تجربة التعريب وليست مهمتي ولا مقصدي في هذه الورقة،
ولم تستطع النخب المعربة تقديم اقتراح ثقافي وتربوي للذهاب في هذا
الاختيار والدفاع عنه، بل إن التعريب كان يقام من قبل النخب المفرنسة، كان
التعريب يجري باللغة الفرنسية وبأطر مفرنسة. وكان المثقف المعرب يبكي
ويبكي، ولا يزال واقفا على الأطلال باكيا حتى يوم الناس هذا. أريد أن أفتح
قوسا هنا للإشارة إلى ذلك النقاش الهام الذي جرى ما بين مفكرين كبيرين
أحدهما ينتمي إلى معسكر العروبية والثاني إلى معسكر الازدواجية اللغوية
وأعني بهما الدكتور عبد الله شريط (الذي يعيش اليوم حالة من التهميش
والنسيان والنكران فتمنياتي له بالصحة الدائمة والإبداع المستمر) والمفكر
المرحوم مصطفى الأشرف. وإذا كان هذا حال المثقف المعرب البارحة فإن حاله
اليوم ليس أفضل من حال الجيل الأول والثاني، جيل الآباء والأجداد، فلا
يزال هذا المثقف بعيدا عن الفعل الثقافي الجاد والحداثي، منشغلا بتصفية
حسابات تافهة وصغيرة تصدر عن مثقف آخر في نفس المعسكر اللغوي أو في غيره.
ولا يزال يبكي ويقف على الأطلال أو يشتم بطريقة الغوغاء.
لم أسمع بمثقف معرب جاد في بلدنا الواسع هذا أطلق مشروعا ثقافيا متينا
خاصا، كما هو الحال في جميع البلدان العربية، كفكرة إنشاء مجلة جادة فكرية
أو أدبية مثلا، وفي المقابل، وعلى هذه الأرض ذاتها تحدث أشياء جميلة
وحلمية في معسكر المثقفين الجزائريين المفرنسين، من هذا الباب دعوني أحيي
الكاتبة والروائية باللغة الفرنسية نادية سبخي ورفيقاتها على تجربتها
الرائدة في قيادة مجلة أدبية باللغة الفرنسية بعنوان "ليفريسك"livresque
وهي المجلة المستقلة الأدبية الوحيدة في الجزائر التي تهتم أساسا بالأدب
الجزائري المكتوب بالفرنسية، وشكرا لها إذ أنها حتى وهي تصدر مجلتها
بالفرنسية لم تقص الأدب الجزائري المكتوب بالعربية.
لم أسمع بمثقف معرب أنشأ مكتبة خاصة ومن ماله الخاص لدعم المطالعة
الثقافية العامة في حين سعدت إذ وجدت أحد المثقفين المفرنسين في سطيف يقود
جمعية ثقافية "فضاءات" وقد حول شقة له إلى مكتبة عامة مفتوحة للرواد تعار
فيها الكتب للعامة ويلتقي فيها المثقفون للنقاش والحوار وتقام فيها
الندوات الفكرية والفلسفية والأدبية ويروج فيها للكتاب، وشكرا أيضا
للروائية الجزائرية مايسة باي التي تكتب باللغة الفرنسية والتي أسست هي
الأخرى مكتبة عمومية للصغار والكبار في مدينة سيدي بلعباس والتي تحولت على
بساطتها وتواضع امكانياتها إلى فضاء أساسي في الفعل الثقافي الجاد،
الهادئ والعميق، وأيضا الشكر والتحية للروائية فاطمة بخاي التي تكتب
بالفرنسية أيضا وإلى فريق (القارئ الصغير) والتي هي الأخرى تقود مع هذا
الفريق المتطوع لثقافة الطفل مكتبة للأطفال بوهران... تلك بعض ما يمكن أن
أذكر وهناك أمثلة أخرى كثيرة ربما سأجيء على ذكرها في مقامات أخرى. سيقوم
بعض المثقفين المعربين على الفور بالرد على ما سقته هنا، الرد جاهز دائما،
وهي ردود معروفة ومكرورة، ردود العاجز، ردود تقوم كالعادة على إطلاق جملة
من التهم على هذه التجارب الثقافية: تهم التخوين والتهويد والتكفير التي
يلصقونها بهؤلاء المبادرين بهذه التجارب التي قد تبدو صغيرة ولكنها عميقة
ومؤثرة وتحمل الكثير من المصداقية والاحترام عند العامة.
هل يقرأ المعرب الجزائري الأدب الروائي ولماذا؟:
تبدو لي صورة الجزائر الثقافية على مستوى القراءة الإبداعية مقسمة إلى
شعبين، شعب (أو لنقل مجموعة اجتماعية) يملك اللغة الفرنسية وبها وفيها يقرأ
الرواية والأدب الخيالي وشعب (أو لنقل مجموعة اجتماعية ثانية) يملك
اللغة العربية وبها ومن خلالها يقاطع القراءة الأدبية والروائية. أريد أن
أنبه هنا إلى شيء أساسي ومنهجي وهو أن اللغة العربية من حيث هي أداة
التوصيل والتبليغ والكتابة لا عيب فيها ولا نقص فيها فاللغة التي حملت
كتاب الله العزيز القرآن الكريم، هي لغة قادرة على حمل كل ما يمكن أن يخطر
على بال المبدع أو الكاتب وما لا يخطر على باله، إلا أن المشكل قائم أولا
في أهلها من النخب التي تعتمدها لغة كتابة ومؤسسة وقراءة وثانيا في سلسلة
المرجعيات السلفية والتقليدية الطاغية التي تقدم للقراء والتي تحولهم إلى
مجموعة ثقافية واجتماعية مناهضة للمعاصرة والتخييل والاجتهاد.
إن تجربة الصحافة الجزائرية الخاصة المكتوبة بالعربية ومنذ انطلاق تجربتها
في بداية التسعينيات استطاعت وبقوة أن تصالح ما بين القارئ الجزائري
والجريدة المعربة، وبدأت القراءة بالعربية تتعافى وتخرج إلى باب القراءة
النقدية، لكن سرعان ما تحول الفضاء الإعلامي بالعربية إلى فضاء تسيطر عليه
مجموعة من الصحف الصفراء همها الأساس هو الحديث عن الجرائم والفتاوى
السلفية المثيرة والغريبة عن مجتمعنا المالكي المتسامح، أمام هذا ففي
الوقت الذي كنا ننتظر أن تغرس هذه الصحف عادة القراءة بالعربية الجادة
وتراكمها وضعت هذه الصحف المعربة (الاستثناء يؤكد القاعدة) القارئ
الجزائري في حالة من العداء لكل ما هو متجدد ومعاصر وحداثي اجتهادي. على
المستوى السوسيو-ثقافي، كنت أنتظر، كسائر المتتبعين لظاهرة القراءة بشكل
خاص وللشأن الثقافي عموما، من تفشي ظاهرة القراءة الصحفية بالعربية، أن
تتحول نسبة ولو قليلة من هؤلاء القراء، الذين أصبحوا يعدون بالملايين حسب
الأرقام الرسمية لسحب الجرائد التي قدمها مؤخرا كاتب الدولة للاتصال السيد
عز الدين ميهوبي، أن تتحول نسبة منهم إلى قراء الكتب الأدبية الإبداعية.
على العكس من هذا الحال فقد تقلص عدد سحب الجرائد الجزائرية بالفرنسية
مقارنة بالسحب باللغة العربية، ولكن جزءا من قراء الصحيفة بالفرنسية
انتقلوا إلى القراءة الأدبية، قراءة الكتاب، وهذا هو الجديد في ساحة
المطالعة اليوم وساحة الكتاب والقراءة الثقافية في بلادنا. وبتحول تقاليد
قراءة الجريدة إلى تقاليد قراءة الكتاب الأدبي والثقافي، من خلال انتقال
مجموعة من قراء الصحيفة بالفرنسية إلى قراءة الرواية، (وأعني هنا أولئك
القراء من الجيل الجديد جيل الربع قرن الأخير) تكون الكتابة الأدبية
بالفرنسية قد ربحت رصيدا هاما من القراء الجدد وأيضا من الكتاب الجدد، أما
القراءة الصحفية بالعربية (الاستثناء يؤكد القاعدة) فبدلا من أن تتحول
إلى قراءة أدبية عميقة ومتحررة فقد تحولت إلى وسيلة لتكريس قراءة الدجل و
وغرس الفكر السلفي المتطرف، وترجع صعوبة عدم انتقال القارئ الصحفي
بالعربية (ولو نسبة قليلة من هذه الملايين) إلى قارئ أدبي مبدع إلى غياب
الكتاب العربي الجاد والمبدع (الجزائري أو العربي) الذي يرافق عملية بناء
وتحصين القارئ بهذه اللغة.
ودليل آخر على هذه القطيعة ما بين القارئ بالعربية في الجزائر والنصوص
الأدبية الروائية هو فشل وإخفاق ترجمات النصوص الناجحة أدبيا وقراءة إلى
العربية لأسماء جزائرية تكتب بالفرنسية عرفت رواجا في سوق الكتاب بالداخل
(أذكر ياسمينة خضرا، مليكة مقدم، أنور بن مالك، بوعلام صنصال، رشيد ميموني
وغيرهم) أو من الكتاب العالميين من أمثال أمين معلوف وغيره. لقد كان هناك
حماس لدى بعض دور النشر الجزائرية (سيديا- مرسى- برزح) لترجمة أعمال بعض
الكتاب الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية وعرفت رواياتهم في اللغة التي
كتبت بها إقبالا كبيرا بين القراء الجزائريين، لكن الترجمات الأولى أكدت
أن القارئ بالعربية لا يهتم لهذه الكتابات وبذلك تراجع الحماس بعد كساد
الروايات المترجمة الأولى.
إن ما أعرضه هنا وبمرارة يحزنني كثيرا ويقلقني كمثقف وكاتب ولكني لن أتوقف
عند طرح المشكل أو البكاء عليه إذ علي ومن باب الشريك اقتراح تصور ثقافي
للخروج من هذه الأزمة. لذا أرى أنه علينا العمل اليوم، دون حسابات سياسوية
موسمية عابرة أو حساسيات شخصية ذاتوية ضيقة، على وضع تقييم شامل وجريء
لما يحصل في باب ما سميته بتشكل "شعبين" (أو مجموعتين اجتماعيتين
وثقافيتين) في بلد واحد بثقافتين وبمخيالين متعارضين أو متقاطعين، مؤكد أن
التنوع شيء إيجابي في الثقافة والإبداع، وأن الشعوب التي تتوفر على مثل
هذا التنوع اللغوي هي لها المناعة ولكن بشرط ألا يتحول هذا الاختلاف إلى
خلاف في المرجعيات وفي المستقبليات أيضا.
لذا علينا ألا نبكي وألا نقف على الأطلال بل الضرورة تحتم علينا وبكل
شجاعة فكرية وثقافية أن نمد الجسور ما بين المجموعات الثقافية واللغوية في
الجزائر على قاعدة حوارات معمقة وغير اقصائية ودون أحكام مسبقة، وحده
الحوار والحلقات الفكرية المسؤولة والجادة قادرة على تبديد الخلاف وتكريس
فلسفة الاختلاف في بلد نريده قويا بثقافته المتنوعة وبمثقفيه على اختلاف
مشاربهم ولغاتهم ورؤاهم، لأننا علينا جميعا، في نهاية المطاف، أن نؤمن بأن
لا تنمية شاملة ومستدامة في غياب ثقافة عميقة ونقدية وأصيلة أو في غياب
المبدع الذي يصنع قيم الخير والسلام والتسامح والحلم والنقد.
من الحزن والمرارة: "المثقف الجزائري المعرب كسول" وعاتبني أيضا، ربما نفس
الأصدقاء، حين قلت وبالمأساة ذاتها: القارئ المعرب لا يعرف قراءة الرواية
وهو يمثل الرقيب الخطير على حرية الإبداع، أخطر من أي رقيب لأية سلطة
قامعة.
واليوم أريد أن أعود إلى هاتين المقولتين لأناقشهما على ضوء تجربتي مع
القراء وانطلاقا من قراءتي الخاصة لمشهد المثقفين ومشهد الثقافة في بلادنا.
أولا في كسل المثقف الجزائري المعرب:
يبدو لي أنه ومنذ الاستقلال لم يقد المثقف المعرب تجربة ثقافية اجتماعية
تغييرية جادة ولم يقدم اقتراحات فاعلة وميدانية استطاعت أن تخلخل المجتمع
الثقافي الجزائري، دون شك الاستثناء يؤكد القاعدة، لقد ظل هذا الفصيل من
المثقفين المعربين يعيش على فتات موائد السلطات المتعاقبة على البلاد
بانتهازية كبيرة وبتقلبات أيديولوجية خطيرة من أقصى اليمين إلى أقصى
اليسار. كان المثقف المعرب في الجزائر وفي جميع المراحل الصعبة التي
قطعتها الدولة الوطنية في تشكلها وتمأسسها توكل له مهمة "التزويق"
و"التبرير" السياسيين، ويكون راضيا عن هذه المهمة، أو يقوم بدور المتفرج
المستقيل من اللعبة دون أن يعلم بأنه، رغما عنه، هو جزء فيها ومحسوب
عليها.
على الرغم من الحماس التاريخي والصادق الشعبي والثقافي والعقائدي الذي
رافق استقلال الجزائر والمتمثل في مديح العروبة سياسيا ولغويا وثقافيا وما
رافقها في المقابل من عداوة وكراهية الفرنسة لغة وسياسة وجغرافيا، إلا أن
المثقف المعرب لم يستطع أن يطرح بديلا تغييريا جادا لا على المستوى
الثقافي ولا على المستوى التربوي، مع أننا ومنذ بداية الاستقلال كنا نملك
نخبا ثقافية معربة كثيرة تعلمت وتخرجت من مدارس وجامعات في كل من تونس
ومصر وسوريا والمغرب والكويت وبغداد، في هذه المرحلة التاريخية الحساسة
أيضا اكتفى المثقف المعرب بالجلوس في مدرج التفرج أو في بيوت العزاء أو
واقفا على شواهد الموتى، ثم جاءت سياسة التعريب مع بداية السبعينيات، وأنا
هنا لا أريد أن أقيم تجربة التعريب وليست مهمتي ولا مقصدي في هذه الورقة،
ولم تستطع النخب المعربة تقديم اقتراح ثقافي وتربوي للذهاب في هذا
الاختيار والدفاع عنه، بل إن التعريب كان يقام من قبل النخب المفرنسة، كان
التعريب يجري باللغة الفرنسية وبأطر مفرنسة. وكان المثقف المعرب يبكي
ويبكي، ولا يزال واقفا على الأطلال باكيا حتى يوم الناس هذا. أريد أن أفتح
قوسا هنا للإشارة إلى ذلك النقاش الهام الذي جرى ما بين مفكرين كبيرين
أحدهما ينتمي إلى معسكر العروبية والثاني إلى معسكر الازدواجية اللغوية
وأعني بهما الدكتور عبد الله شريط (الذي يعيش اليوم حالة من التهميش
والنسيان والنكران فتمنياتي له بالصحة الدائمة والإبداع المستمر) والمفكر
المرحوم مصطفى الأشرف. وإذا كان هذا حال المثقف المعرب البارحة فإن حاله
اليوم ليس أفضل من حال الجيل الأول والثاني، جيل الآباء والأجداد، فلا
يزال هذا المثقف بعيدا عن الفعل الثقافي الجاد والحداثي، منشغلا بتصفية
حسابات تافهة وصغيرة تصدر عن مثقف آخر في نفس المعسكر اللغوي أو في غيره.
ولا يزال يبكي ويقف على الأطلال أو يشتم بطريقة الغوغاء.
لم أسمع بمثقف معرب جاد في بلدنا الواسع هذا أطلق مشروعا ثقافيا متينا
خاصا، كما هو الحال في جميع البلدان العربية، كفكرة إنشاء مجلة جادة فكرية
أو أدبية مثلا، وفي المقابل، وعلى هذه الأرض ذاتها تحدث أشياء جميلة
وحلمية في معسكر المثقفين الجزائريين المفرنسين، من هذا الباب دعوني أحيي
الكاتبة والروائية باللغة الفرنسية نادية سبخي ورفيقاتها على تجربتها
الرائدة في قيادة مجلة أدبية باللغة الفرنسية بعنوان "ليفريسك"livresque
وهي المجلة المستقلة الأدبية الوحيدة في الجزائر التي تهتم أساسا بالأدب
الجزائري المكتوب بالفرنسية، وشكرا لها إذ أنها حتى وهي تصدر مجلتها
بالفرنسية لم تقص الأدب الجزائري المكتوب بالعربية.
لم أسمع بمثقف معرب أنشأ مكتبة خاصة ومن ماله الخاص لدعم المطالعة
الثقافية العامة في حين سعدت إذ وجدت أحد المثقفين المفرنسين في سطيف يقود
جمعية ثقافية "فضاءات" وقد حول شقة له إلى مكتبة عامة مفتوحة للرواد تعار
فيها الكتب للعامة ويلتقي فيها المثقفون للنقاش والحوار وتقام فيها
الندوات الفكرية والفلسفية والأدبية ويروج فيها للكتاب، وشكرا أيضا
للروائية الجزائرية مايسة باي التي تكتب باللغة الفرنسية والتي أسست هي
الأخرى مكتبة عمومية للصغار والكبار في مدينة سيدي بلعباس والتي تحولت على
بساطتها وتواضع امكانياتها إلى فضاء أساسي في الفعل الثقافي الجاد،
الهادئ والعميق، وأيضا الشكر والتحية للروائية فاطمة بخاي التي تكتب
بالفرنسية أيضا وإلى فريق (القارئ الصغير) والتي هي الأخرى تقود مع هذا
الفريق المتطوع لثقافة الطفل مكتبة للأطفال بوهران... تلك بعض ما يمكن أن
أذكر وهناك أمثلة أخرى كثيرة ربما سأجيء على ذكرها في مقامات أخرى. سيقوم
بعض المثقفين المعربين على الفور بالرد على ما سقته هنا، الرد جاهز دائما،
وهي ردود معروفة ومكرورة، ردود العاجز، ردود تقوم كالعادة على إطلاق جملة
من التهم على هذه التجارب الثقافية: تهم التخوين والتهويد والتكفير التي
يلصقونها بهؤلاء المبادرين بهذه التجارب التي قد تبدو صغيرة ولكنها عميقة
ومؤثرة وتحمل الكثير من المصداقية والاحترام عند العامة.
هل يقرأ المعرب الجزائري الأدب الروائي ولماذا؟:
تبدو لي صورة الجزائر الثقافية على مستوى القراءة الإبداعية مقسمة إلى
شعبين، شعب (أو لنقل مجموعة اجتماعية) يملك اللغة الفرنسية وبها وفيها يقرأ
الرواية والأدب الخيالي وشعب (أو لنقل مجموعة اجتماعية ثانية) يملك
اللغة العربية وبها ومن خلالها يقاطع القراءة الأدبية والروائية. أريد أن
أنبه هنا إلى شيء أساسي ومنهجي وهو أن اللغة العربية من حيث هي أداة
التوصيل والتبليغ والكتابة لا عيب فيها ولا نقص فيها فاللغة التي حملت
كتاب الله العزيز القرآن الكريم، هي لغة قادرة على حمل كل ما يمكن أن يخطر
على بال المبدع أو الكاتب وما لا يخطر على باله، إلا أن المشكل قائم أولا
في أهلها من النخب التي تعتمدها لغة كتابة ومؤسسة وقراءة وثانيا في سلسلة
المرجعيات السلفية والتقليدية الطاغية التي تقدم للقراء والتي تحولهم إلى
مجموعة ثقافية واجتماعية مناهضة للمعاصرة والتخييل والاجتهاد.
إن تجربة الصحافة الجزائرية الخاصة المكتوبة بالعربية ومنذ انطلاق تجربتها
في بداية التسعينيات استطاعت وبقوة أن تصالح ما بين القارئ الجزائري
والجريدة المعربة، وبدأت القراءة بالعربية تتعافى وتخرج إلى باب القراءة
النقدية، لكن سرعان ما تحول الفضاء الإعلامي بالعربية إلى فضاء تسيطر عليه
مجموعة من الصحف الصفراء همها الأساس هو الحديث عن الجرائم والفتاوى
السلفية المثيرة والغريبة عن مجتمعنا المالكي المتسامح، أمام هذا ففي
الوقت الذي كنا ننتظر أن تغرس هذه الصحف عادة القراءة بالعربية الجادة
وتراكمها وضعت هذه الصحف المعربة (الاستثناء يؤكد القاعدة) القارئ
الجزائري في حالة من العداء لكل ما هو متجدد ومعاصر وحداثي اجتهادي. على
المستوى السوسيو-ثقافي، كنت أنتظر، كسائر المتتبعين لظاهرة القراءة بشكل
خاص وللشأن الثقافي عموما، من تفشي ظاهرة القراءة الصحفية بالعربية، أن
تتحول نسبة ولو قليلة من هؤلاء القراء، الذين أصبحوا يعدون بالملايين حسب
الأرقام الرسمية لسحب الجرائد التي قدمها مؤخرا كاتب الدولة للاتصال السيد
عز الدين ميهوبي، أن تتحول نسبة منهم إلى قراء الكتب الأدبية الإبداعية.
على العكس من هذا الحال فقد تقلص عدد سحب الجرائد الجزائرية بالفرنسية
مقارنة بالسحب باللغة العربية، ولكن جزءا من قراء الصحيفة بالفرنسية
انتقلوا إلى القراءة الأدبية، قراءة الكتاب، وهذا هو الجديد في ساحة
المطالعة اليوم وساحة الكتاب والقراءة الثقافية في بلادنا. وبتحول تقاليد
قراءة الجريدة إلى تقاليد قراءة الكتاب الأدبي والثقافي، من خلال انتقال
مجموعة من قراء الصحيفة بالفرنسية إلى قراءة الرواية، (وأعني هنا أولئك
القراء من الجيل الجديد جيل الربع قرن الأخير) تكون الكتابة الأدبية
بالفرنسية قد ربحت رصيدا هاما من القراء الجدد وأيضا من الكتاب الجدد، أما
القراءة الصحفية بالعربية (الاستثناء يؤكد القاعدة) فبدلا من أن تتحول
إلى قراءة أدبية عميقة ومتحررة فقد تحولت إلى وسيلة لتكريس قراءة الدجل و
وغرس الفكر السلفي المتطرف، وترجع صعوبة عدم انتقال القارئ الصحفي
بالعربية (ولو نسبة قليلة من هذه الملايين) إلى قارئ أدبي مبدع إلى غياب
الكتاب العربي الجاد والمبدع (الجزائري أو العربي) الذي يرافق عملية بناء
وتحصين القارئ بهذه اللغة.
ودليل آخر على هذه القطيعة ما بين القارئ بالعربية في الجزائر والنصوص
الأدبية الروائية هو فشل وإخفاق ترجمات النصوص الناجحة أدبيا وقراءة إلى
العربية لأسماء جزائرية تكتب بالفرنسية عرفت رواجا في سوق الكتاب بالداخل
(أذكر ياسمينة خضرا، مليكة مقدم، أنور بن مالك، بوعلام صنصال، رشيد ميموني
وغيرهم) أو من الكتاب العالميين من أمثال أمين معلوف وغيره. لقد كان هناك
حماس لدى بعض دور النشر الجزائرية (سيديا- مرسى- برزح) لترجمة أعمال بعض
الكتاب الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية وعرفت رواياتهم في اللغة التي
كتبت بها إقبالا كبيرا بين القراء الجزائريين، لكن الترجمات الأولى أكدت
أن القارئ بالعربية لا يهتم لهذه الكتابات وبذلك تراجع الحماس بعد كساد
الروايات المترجمة الأولى.
إن ما أعرضه هنا وبمرارة يحزنني كثيرا ويقلقني كمثقف وكاتب ولكني لن أتوقف
عند طرح المشكل أو البكاء عليه إذ علي ومن باب الشريك اقتراح تصور ثقافي
للخروج من هذه الأزمة. لذا أرى أنه علينا العمل اليوم، دون حسابات سياسوية
موسمية عابرة أو حساسيات شخصية ذاتوية ضيقة، على وضع تقييم شامل وجريء
لما يحصل في باب ما سميته بتشكل "شعبين" (أو مجموعتين اجتماعيتين
وثقافيتين) في بلد واحد بثقافتين وبمخيالين متعارضين أو متقاطعين، مؤكد أن
التنوع شيء إيجابي في الثقافة والإبداع، وأن الشعوب التي تتوفر على مثل
هذا التنوع اللغوي هي لها المناعة ولكن بشرط ألا يتحول هذا الاختلاف إلى
خلاف في المرجعيات وفي المستقبليات أيضا.
لذا علينا ألا نبكي وألا نقف على الأطلال بل الضرورة تحتم علينا وبكل
شجاعة فكرية وثقافية أن نمد الجسور ما بين المجموعات الثقافية واللغوية في
الجزائر على قاعدة حوارات معمقة وغير اقصائية ودون أحكام مسبقة، وحده
الحوار والحلقات الفكرية المسؤولة والجادة قادرة على تبديد الخلاف وتكريس
فلسفة الاختلاف في بلد نريده قويا بثقافته المتنوعة وبمثقفيه على اختلاف
مشاربهم ولغاتهم ورؤاهم، لأننا علينا جميعا، في نهاية المطاف، أن نؤمن بأن
لا تنمية شاملة ومستدامة في غياب ثقافة عميقة ونقدية وأصيلة أو في غياب
المبدع الذي يصنع قيم الخير والسلام والتسامح والحلم والنقد.





 ]
]